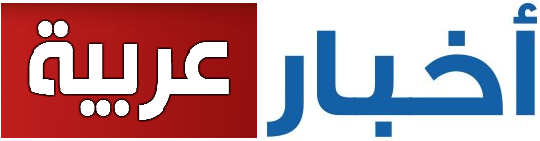| سكينة السمرة |
“يا غايب”.. ليست مجرد أغنية من أغاني فضل شاكر، بل باتت اليوم عنواناً يحاول منه الفنان “التائب” العودة إلى الأضواء عبر وثائقي يحمل اسم أغنيته الشهيرة.
العمل الذي تعرضه منصة “شاهد” يفتح أبواباً واسعة للتأمل في الدور الذي تلعبه الوسائط الفنية في تشكيل الوعي العام، حيث تُقدم شخصية شاكر في صورة تُغلفها المشاعر والدموع.
في قلب هذا الجدل، تتقاطع الأسئلة الأخلاقية والفنية: هل من حق الفن أن يمنح منبراً لمن لم يطوِ بعد صفحته مع العدالة؟ وهل تتحول الأعمال الفنية أحياناً إلى أدوات تلميع، تُعيد رسم الواقع كما يُراد له أن يُرى؟
“يا غايب ليه ما تسأل ع احبابك اللي يحبونك” هكذا تبدأ أحد أشهر أغاني شاكر، والتي لم يكن اعتباطياً اختيار كلماتها عنواناً لعمل يحاول فيه شاكر “الغايب” ربما تبرير نفسه لنفسه قبل الجمهور.
من المؤكد أنني لست وحدي من عاش الصراع بين حب صوت فضل شاكر “ملك الإحساس” الذي كبرنا على صوته وعاشت قصصنا على أغانيه، وبين رفض خياراته من 2013 وما وقع بعدها.
الخيارات نفسها التي يحاول فضل وضعها في خانة الاتهامات. واليوم ينقسم الجمهور العربي واللبناني بخاصةً بين مدافع ومهاجم ومبرر، وبين من يقتنع بخطأ شاكر ولكنه لم يستطع خوض المقاطعة سبيلاً للتعبير عن ذلك.
“يا غايب”
تعرض “شاهد” التابعة لمجموعة “أم بي سي” الوثائقي الذي يعرض قصة المغني اللبناني ويجسد شخصيته في شبابه الممثل الأردني عماد المحتسب، من إنتاج شركة “2pure Studios”. يذرف شاكر، الإنسان والأب والفنان واليتيم، الكثير من الدموع في الوثائقي، يحاول تبرئة نفسه، استعطاف الجمهور، والحديث عن بداياته الصعبة منذ أن تربى في دار الأيتام وخوضه معارك في الحب على سطوح مخيم عين الحلوة وصولاً إلى عالم الشهرة.
في وثائقي “يا غايب”، يظهر فضل شاكر محاطاً بعناصر إنسانية تغلب عليها العاطفة: ذكريات الطفولة، قصص الحب على أسطح المخيم، مشوار النجومية، والدموع التي تتكرر في مشاهد متعددة. لا شك أن العمل مُتقن فنياً، لكن ما يثير الجدل هو الطريقة التي يُعاد فيها تقديم شاكر كشخصية مغبونة أكثر من كونه طرفاً في قضايا لم يُبتّ فيها حتى الآن.
الوثائقي لا ينكر الماضي، لكنه يُعيد تأطيره بلغة تُخفف من وقعه، وتفتح المجال أمام تبريرات لا تخلو من الاستعطاف، ما يجعله أقرب إلى محاولة تبرئة ذاتية مغلفة بسرد درامي، لا إلى توثيق موضوعي لحياة معقدة ومليئة بالمحطات المتشابكة.
في البداية، انقسم الجمهور بشأن فكرة إنتاج الوثائقي، إذ رحب العديد بالفكرة معتبرين أن ذلك سيكشف عن الكثير من الاتهامات التي طالته، بينما عارض آخرون ذلك، حتّى أُثير العديد من التكهنات حول احتمال التراجع عن بث العمل.
ولكن في الحقيقة ليس من السهل اليوم على الكثيرين أن ينسوا ظهور شاكر في الفيديوهات والصور حاملاً السلاح، حين اعتبر أنّه وجد الطريق الصحيح، وتبرأ من الغناء، أو حين وصف شهداء الجيش اللبناني “بالفطايس”، علماً أنه كان قد برر أن المقصود بكلامه ليس الجيش.
وعلى الرغم من تداول خبر تبرئته من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني مؤخراً، وفي أول تعليق له حول ذلك، أكد شاكر عبر “إكس”: “أن المعلومات تفتقر إلى الدقة”، نافياً صدور حكم جديد ببراءته من المحكمة العسكرية.
وأوضح “أن الحكم المتعلق بأحداث عبرا يعود بالتاريخ إلى عام 2018، حيث قضت المحكمة بهيئتها بالإجماع بمنع المحاكمة غيابياً لجهة الاقتتال مع الجيش اللبناني وعدم المشاركة بالمعركة أساساً”.
وصرح عبر حسابه “أن القضايا الأخرى العالقة لا تزال قيد المتابعة أمام القضاء العسكري، ومنها اتهامات بالتدخل بالإرهاب وتبييض الأموال وتعكير صلة لبنان بإحدى الدول”.
الأعمال الفنية: أداة لتلميع الواقع
في كثير من الأحيان، تُستخدم الأعمال الفنية كوسيلة لتلميع الواقع من خلال تسليط الضوء على شخصيات معينة وتقديمها بصورة مثالية أو بطولية، تتجاوز ما هو حقيقي أو واقعي. فترى في الأفلام، والمسلسلات، واللوحات الفنية، تصويراً لشخصيات سياسية أو اجتماعية أو تاريخية بطريقة تُمجّد إنجازاتهم وتتجاهل أخطاءهم أو جوانبهم السلبية وتهمش الحقائق المُزعجة.
هذه الممارسات تلعب دوراً ليس عادياً في إعادة تشكيل صورة الواقع. وهكذا، تصبح الصورة الفنية أداة لتجميل الواقع، وليست مرآة له.
الجمهور بين الذاكرة والعاطفة
انقسام الجمهور حول فضل شاكر ليس جديداً. البعض لا يزال أسير صوته المميز وذكريات الطفولة والمراهقة التي رافقها، بينما يرى آخرون أن الفن الجميل لا يُلغي التاريخ الشخصي لصاحبه. وبين المدافع والمهاجم، يقف كثيرون على الحياد.
لا أحد ينكر أن لكل إنسان الحق في فرصة ثانية، ولكن هذا الحق لا يكتمل إلا حين تُقال الحقيقة كاملة، وحين يُنجز مسار العدالة قبل مسار الفن.
وثائقي “يا غايب” أعاد فضل شاكر إلى المشهد، لكن ليس كصوت فقط، بل كحالة جدلية تختبر الحدود بين الفن والمحاسبة، بين التعاطف والإنصاف. فهل تبقى العدالة الطريق الوحيد لعودة حقيقية لشاكر لا تُجمّلها الكاميرا بل يُنصفها القانون؟!