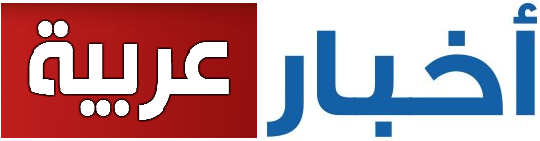إذن، وبعد أن صرَّح الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيحول السعودية إلى دولة “معزولة”، يعود سيد البيت الأبيض اليوم ليدقَّ باب الرياض، خاطباً ودها وطالباً منها المزيد من المساعدة لحل أزمة الطاقة التي تتفاقم في العالم –وفي الغرب على وجه التحديد– بعد العقوبات التي فُرضت على روسيا، والمقاطعات الكثيرة التي جاءت إثر إعلان الأخيرة الحرب على جارتها أوكرانيا.
وإذا كان كثيرون يرون أن هذا هو سبب زيارة بايدن الوحيد للسعودية، إلا أني أراه السبب المباشر الذي يخفي وراءه مجموعة متنوعة من الأسباب البعيدة والدواعي غير المباشرة.
لن يأتي الرئيس الأميركي وفي جعبته ملف واحد، حتى لو كان بأهمية ملف الطاقة، بل سيحمل مجموعة من الملفات الأخرى الساندة والداعمة، والتي سيفاوض عليها ومن خلالها، وأهمها برأيي إعادة ترتيب العلاقة بين أميركا ودول المنطقة من جديد، اذ تدرك واشنطن ضرورة أن يبدأ هذا الأمر من السعودية أولاً، بخاصة بعدما عجزت زيارتا بلينكن وجونسون عن إحداث أي أثر يُذكر بهذا الصدد.
ومن جهة ثانية، من المتوقع أن تكون القيادة في السعودية على المستوى ذاته من الاستعداد، وأن تكون ملفاتها أيضاً جاهزة، وأوراق لعبها كاملة، فالفرصة الدبلوماسية سانحة، سواء بسبب اللحظة التاريخية أم بسبب المناسبة المباشرة.
يفترض إذاً أن تعني زيارة بايدن المرتقبة للسعودية إنهاءً للابتزاز السياسي الذي تعرضت له المملكة، والذي وقفت وراءه أسباب عديدة أصبحت اليوم -على ما يبدو- من الماضي. ولدى الملك سلمان الآن، وولي عهده الأمير محمد، وبعد أن تمكنت القيادة السعودية من تفكيك المتاهة الدولية التي أجبرت على دخولها، فرصة في غاية الأهمية لإعادة تثبيت الصورة الصحيحة والتي تعبر بشكل مناسب عن مشروع القيادة السعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وليترسخ دور المملكة كلاعب محوري إقليمياً ودولياً، ولقد أثبتت التجربة قدرة القيادة السعودية على فهم ديناميات النظام الدولي العالمي، وقواعد التفاعل القائم على المصالح بين فواعله وأقطابه، واستطاعت الرياض أن تثبّت مكانها المركزي في تلك المعادلة حتى عندما كانت الولايات المتحدة ذاتها في الطرف الآخر.
ومما يجب أن تضعه الإدارة الأميركية بالحسبان أن سبب توتر العلاقات مع المملكة ليس الصين ولا روسيا ولا أي دولة أخرى سوى الولايات المتحدة ذاتها، والسياسات التي انتهجتها على امتداد ولايات عدة وإدارات متعاقبة، فبدل أن تبقى واشنطن –كما كانت دائماً– حليف الرياض الأول والأهم، أخذت تختلق الحجج والذرائع لتخفيض مستوى العلاقة، وللحدِّ بالعموم من التزامها حيال المنطقة، في الوقت الذي كانت السعودية تتوقع الأكثر من حليفها التقليدي، بخاصة وهي تواجه تحديات عديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
داخلياً.. أعلنت القيادة السعودية “ثورة اجتماعية” كاملة وأطلقت مشروعاً تنموياً ضخماً وشاملاً هو “رؤية 2030” الغني عن التعريف، هذا المشروع الضخم الرامي إلى نقل المملكة إلى مستويات متقدمة جداً من الانفتاح الاجتماعي والثقافي، والتطور التكنولوجي والاقتصادي، والتحرر من الريعية القائمة على إنتاج النفط وحده.
أطلقت السعودية رؤيتها هذه في وقت تواجه فيه كثيراً من التحديات على الصعيد الخارجي أيضاً، فقد زادت مسؤولياتها كثيراً، بعد تراجع القوى التقليدية العربية، وصار الحفاظ على أمن المنطقة وسلامها واستقرارها يقع في جزء كبير منه على عاتق المملكة بشكل رئيس، سواء من ناحية مواجهة التهديد الإيراني الذي مازال يستفحل في الدول العربية، أم من ناحية الوصول إلى حل مقبول للقضية الفلسطينية، ينهي الصراع العربي الإسرائيلي الممتد لعقود والذي يكلف منطقتنا الكثير ويعرقل محاولات التطوير والتحديث فيها، أو حتى من ناحية إيجاد حلول لمشكلات عربية عالية التعقيد، كالملف السوري والعراقي واللبناني وغيرها.
عندما تجد المملكة أن حليفها التقليدي غير ملتزم بعلاقتهما، من الطبيعي أن تبدأ البحث عن حلفاء جدد، في زمن لا يمكن لأي دولة فيه أن تحل كل مشكلاتها وحدها، حتى لو كانت الولايات المتحدة ذاتها، وزيارة بايدن اليوم دليل على ذلك. ولا أنكر بالطبع أن أميركا هي الحليف المفضل للسعوديين، وقد لمست ذلك شخصياً خلال زياراتي للمملكة ونقاشاتي وحواراتي مع الكثير من أبنائها، رسميين كانوا أم مواطنين عاديين، ولذلك فقد تضاعفت خيبة أملهم من مواقف واشنطن السياسية حيال بلادهم خلال السنة والنصف الماضيتين، ففي الوقت الذي يخوضون فيه معركة التغيير والإصلاح الوطني الضارية، يخرج الحلفاء بالتصريح أنهم يريدون السعودية “منبوذة” أو دولة “دون أي قيمة”.
يجب أن تدرك أميركا أن تفضيل السعودية لها لا ينبع من قلة الحلفاء الممكنين، فهم كثر ويمتلكون الكثير من القوة التي يستطيعون تقديمها للمملكة، فالعلاقة مع بكين مثلاً ليست قائمة على بيعها النفط السعودي فقط، بل يمكن أن تمتد إلى تعاون عسكري وإنشاء معامل حربية صينية في السعودية، وشراء الصواريخ البالستية الصينية.. وروسيا أيضاً حاضرة وما زيارة بايدن اليوم إلا نتيجة لالتزام المملكة بالاتفاق مع موسكو في إطار “أوبك +”. وعليه يجب أن تعلم الإدارة الأميركية أن السعودية لن ترضخ لسياسة المعايير المزدوجة، فلن تقف متفرجة لترى واشنطن تسحب منها بطاريات “الباتريوت” وتكتفي بإدانة هجمات الحوثيين التي استهدفت أرامكو، وتستجيب بالمقابل للانخراط بشكل عالي المستوى في دعم أوكرانيا ضد روسيا، بينما واشنطن ما زالت ترفض إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
زيارة بايدن للسعودية بحد ذاتها أمرٌ جيد، فالتواصل المباشر هو أفضل أنواع التواصل، لكن مجريات هذه الزيارة ومنعكساتها على الملفات التي تنخرط فيها المملكة وعلى التحديات التي تواجهها هي المحك الذي سيحدد مدى نجاح السعودية في استثمار تحركاتها السياسية على امتداد الأعوام الأخيرة الماضية.
لقد أثبتت المملكة قدرتها على الإنجاز في السياسة والاقتصاد والمجتمع، إذ تمتلك اليوم علاقات مميزة مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الخارجة منه، وتتعزز باستمرار مكانتها كقائد موثوق للعالم العربي، والإسلامي أيضاً، وقد شهدنا أخيراً زيارة الرئيسين التركي والباكستاني لها، زيارتان تحملان من المعاني والدلالات الكثير. ليس آخرها إقرار الدولتين الإقليميتين بمركزية الدور السعودي وأهميته إقليمياً وإسلامياً وعالمياً.
أما اقتصادياً فقد حقق ارتفاع أسعار النفط للمملكة عوائد هائلة وتقدر بعض المصادر أن ناتجها المحلي الإجمالي لهذا العام قد يتجاوز الترليون دولار، ومع ذلك قادت أخيراً كبار منتجي النفط لزيادة كبيرة غير متوقعة في الإنتاج بلغت نحو 400 ألف برميل يومياً، في بادرة حسن نية مقابل تغير اللهجة الأميركية تجاهها.
إذا أرادت أميركا تعاون الرياض في إيجاد بدائل للنفط والغاز الروسيين، بما يضمن تخفيض أسعار الطاقة فيها وإيقاف الهيجان الشعبي الأميركي والأوروبي ضد حكوماتهم وبالتالي فوز الإدارة الحالية في الانتخابات النصفية القادمة من جهة، وتجريد روسيا من أقوى أوراق الضغط لديها من جهة ثانية، على الإدارة الاميركية ان تدرك تماماً ان لا شيء يُقدم مجاناً، والبراغماتية مطلوبة في العمل السياسي، فهناك أثمان يجب أن تدفع. والأثمان هنا ليست لمصلحة المملكة نفسها، بل لمصلحة المنطقة كلها، ولمصلحة أميركا ذاتها. فما الذي تريده المملكة؟
أهم ما تسعى اليه الرياض اليوم هو جعل المنطقة بيئة إقليمية مستقرة وهادئة ينتفي فيها التهديد الإيراني المستمر، وليس المطلوب هنا من الولايات المتحدة أن تنبري لشن حرب ضد طهران، فالمملكة مستمرة بالحوار مع “جارتها اللدودة”، والمهم هنا أن لا يؤدي التعامل الأميركي مع طهران إلى إفشال هذا الحوار، وأخيراً وأولاً تريد السعودية تقدماً ملموسا في القضية الفلسطينية برعاية أمريكية، إذ سيمثل ذلك بلا شك حجر الأساس في السلام في المنطقة. هذه بإيجاز التحديات التي تواجهها المملكة، وأهم ما يجب التصدي له في الزيارة المرتقبة، ولئن عرضتها الآن باختصار قد أعود للحديث عنها بشكل أكثر تفصيلاً في مقال لاحق.
لقد استطاعت المملكة أن تحقق هذا “الفوز الدبلوماسي” ليس بسبب النفط وحده بل بسبب المرونة العالية التي أبدتها في التعاطي مع الأزمات والمتغيرات الدولية بالعموم، وفي مواقفها حيال الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا بالخصوص. ولقد أثبتت الرياض أنها رقم صعب، وأن علاقتها بواشنطن ليست تحصيلاً حاصلاً. والآن بات لزاماً على المملكة أن تعمل لحصد الكم الأكبر من المكتسبات، فالأميركيون حكماً يعملون ويخططون ويسابقون الزمن، لتعظيم مكتسباتهم وما سيحصلون عليه من المملكة.
ومن نافل القول إن على المملكة أن تجهز كل الملفات الإقليمية، فالأمر لا يقتصر على الطاقة ومكافحة الإرهاب، المجالين اللذين كثيراً ما انحصر التعاون الأميركي السعودي فيهما.. الأمور اليوم مختلفة وبايدن اليوم، وإدارته بالعموم مستعدان للتعاون. ومثلما سيكون موضوع زيادة إنتاج النفط، والعلاقات العربية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية، حاضرة في اجتماع القيادات السعودية مع بايدن، كذلك يجب أن تكون الملفات الأخرى، وبخاصة سوريا والعراق ولبنان، وأركز هنا على الملف السوري بالتحديد، بخاصة أن معظم العراقيل التي أعاقت تطبيع علاقات سوريا مع محيطها العربي كانت مرتبطة بموقف واشنطن، سواء بشكل غير مباشر عبر تحفظها على إعادة تطبيع علاقاتها مع دول عربية، أم بشكل مباشر عبر تداعيات قانون قيصر واستمرار تجديد سياسة العقوبات. وليس بخاف على أحد ما للملف السوري من تأثيرات، تبدأ من احتواء النفوذ الإيراني في الدول العربية، ولا تنتهي عند ترسيخ دور المملكة كمرجع ووسيط موثوق، قادر على إيجاد المخارج من أزمات المنطقة.
في الختام، ستكون نتائج المرحلة الأولى من جولة الرئيس الأميركي للمنطقة، أي زيارة المملكة والاجتماع بقيادتها، معيار نجاح المراحل التالية، وأهمها اجتماع القمة الثاني الذي سيضم قادة دول مجلس التعاون، بالإضافة الى قادة دول عربية أخرى، مصر والأردن والعراق، في استعادة تاريخية لحدث دولي إقليمي يتوقع منه أن يكون فارقاً في تاريخ المنطقة لعقود قادمة.